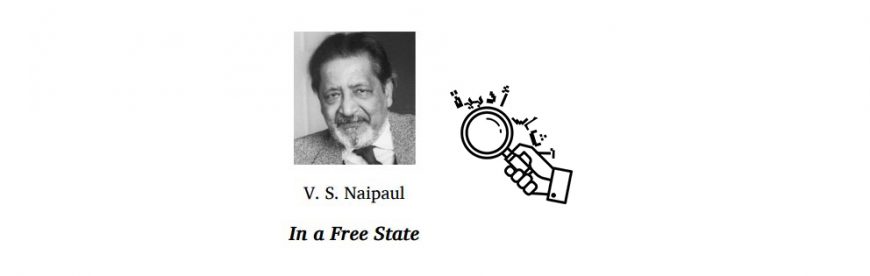في عمله المقصود بهذا التعليق، (في بلد حر) الصادر عام 1971، والفائز بجائزة البوكر الإنجليزية عن نفس العام، ينتاب القارئ في البداية بعض الإرتباك أمام الشكل الذي صدر به الكتاب المصنف كـ(رواية)، ثلاثة روايات قصيرة منفصلة جُمعت معاً، (واحد من كثيرون) و(قل لي من أقتل) و (في بلد حر). من الأخيرة يأتي عنوان الكتاب كله، وهي القصة الرئيسية فيه والتي أعاد نايبول استثمارها بعد ذلك آخذاً بنصيحة محررته الأدبية، فقام بنشرها وحدها لاحقاً في كتيب منفصل.
لم يكن هذا فحسب هو مصدر الإرتباك، ولكن حقيقة تغليف الروايات القصيرة الثلاث بمفتتح وخاتمة مقتبسين من مذكرات الكاتب الخاصة، النصين الذين يمكن أن يُجازا بسهولة كقصتين قصيرتين، ليصير <الكتاب/الرواية> في النهاية عبارة عن خمسة نصوص أدبية منفصلة ظاهرياً لا يربط بينها سوي السر المختبئ في كل مناظر نايبول.
الحقيقة الأخري هي موضع ملامسة هذان النصان، المفتتح والخاتمة، الملفت للنظر، وهو مصر، وهي فيما أعرف ضمن بلدان أخري تمثل موضع المركز للإسلام لم تشغل مواضع كثيرة ضمن إنتاج نايبول مثل الذي شغلته بلدان الأطراف الإسلامية غير العربية مثل الهند وإيران وباكستان وماليزيا وأندونسيا.
فما الذي أراد نايبول قوله بقصتيه المصريتين القصيرتين عبر وضعهما كمفتتح وخاتمة لثلاثة قصص كبيرة غير ذات علاقة بمصر؟
يُقرأ عمل عمر ف.س.نايبول كله، الروائي منه وغير الروائي، كأنه عمل واحد كبير متصل. برغم اتساع رقعة الأهتمام الجغرافية في عمله، لتشمل بداية البحر الكاريبي، موطن ميلاده، إلي إنجلترا وأوروبا، الألما ماتر وفرصة التكوّن الثقافي والعمل الأحترافي المؤسسي الأول والهوي العقلي، ثم آسيا، وهي المنبت والجذور، حيث ورث ملامحه الهندية، وحتي أفريقيا، التي أعطته فتراته التدريسية في جامعاتها ككاتب مقيم كافه رواياته الأفريقية، إلا أن هذا الإتساع الظاهري، كوني المقاس، والذي يتوزع علي دستتين تقريباً من الروايات وكتب الرحلات والمقالات، يمكن أن يتلخص كله، ويُقتفي أثر سطوره الباطنة كلها، من فكرة شديدة البساطة في قصرها، شديدة الصرامة في قلة تعاطفها. هذه الفكرة هي تقسيم العالم إلي مُتعلمين وغير مُتعلمين.
لا يعبر نايبول عن قسمته هذه صراحة، إنه كاتب “مناظر” بالأساس، راسم، يخلق بقلمه لوحات فنية إستاتيكية تقليدية لأوقات تبدو طويلة أحياناً ضمن صفحات كتبه، شارع ميجول في ترينيداد، غرفة التحرير في مكتب BBC، السهول والجبال والليل الأفريقي، معابر النيل في الأقصر، محطات القطار في الهند، الأطلال الأثرية في باكستان، ثم تتحرك هذه الصورة شيئاً فشيئاً فتجري فيها الأحداث العنيفة، بطبيعية وبلا تعليق، الأنقلابات العسكرية في أفريقيا والقتل في الشوارع، الأنهيار النفسي للهنود في أوروبا أمام الملذات، جلد أطفال الشارع بالسياط في الأقصر أمام السائحين، فيبدو أحياناً كأنه يقدم تقريراً إخبارياً، لكنه تقرير إخباري فني، بُذلت في صناعته جهود الصياغة والتحرير الرفيعين المتمهلين.
هكذا الأمر أيضاً هنا في القصص الثلاث (واحد من كثيرون) و(قل لي من أقتل) و (في بلد حر). فالأولي قصة خادم هندي يرحل مع سيده الدبلوماسي إلي واشنطن دي سي فقط لتزداد ضآلته هناك فيحاول الهرب وتشكيل حياة جديدة تحت الأرض عنوانها الخوف من الترحيل. والثانية عن كفاح الأخ الأكبر من عائلة هندية في إنجلترا لتأمين مصاريف دراسة الأخ الأصغر لهندسة الطيران هناك، ليكتشف في النهاية فشل الأخ في مسعاه نحو آمال كبيرة واكتفاءه بالزواج، وبالتالي فشل أهداف كفاحه ومسعاه هو الشخصي.
وإذا كان ما يجمع القصتين الأولين هو الهند، فأن القصة الثالثة، الرئيسية، هي قصة أفريقية، حول رحلة طريق بالسيارة تجمع بين رجل وامرأة بريطانيين في بلد أفريقية حديثة العهد بالأستقلال حيث الفنادق تحتفي بصور الرئيس الجديد وطائرات الهيلكوبتر تبحث بأستمرار عن الملك الهارب. ينقل الراوي خلال الرحلة صورة ملخصها بؤس المحليين وعنف وفساد الجيش والشرطة واعتماد الجميع البائس في عصرهم الجديد علي الثياب والمظاهر الإنجليزية.
العناصر الظاهرة في هذه القصص الثلاث تتكرر دائماً في كل إنتاج نايبول الأدبي والبحثي، هناك دائماً محليين فقراء يعانون من عسف وقهر مستعمرين متحضرين، لكن في نفس الوقت يُطرح السؤال غير المباشر: ماذا سيحدث لو رحل المستعمر وتُرك المحليين لأنفسهم؟
وأما القصص المصرية إن جاز تسميتهما كذلك، فالأولي منهما، أقلهما مصرية، تحكي يومية الراوي –نايبول نفسه- علي مركب يوناني متهالك عائد من اليونان إلي الإسكندرية، حاملاً علي سطحه مجموعة من البشر المختلفين، يونانيين، وأمريكان، وألمان، ولبنانيين، ومصريين. يجب أن ننتبه هنا للجملة النادرة في وضوحها التي وصف بها نايبول اليونانيين العائدين، وصف خروجهم من مصر بأنه كان ثمناً للحرية. لا تظهر هذه الجمل عادة في أدب نايبول، ربما لأن القصة مرة أخري من نوع اليوميات. المهم أنه في القلب من هذه المجموعة من البشر قد جعل نايبول بينهم متشرداً إنجليزياً غامضاً، يقول أنه ربما بدا له إنجليزياً نظراً لأنه لم يكن هناك إنجليز آخرين بالجوار، لكن انظر كيف قدم له برومانسية واصفاً ما يمكن أن تحويه حقيبته الرثة: “كتاباً للشعر، مدونة يوميات، أو مخطوط رواية”، هذا المقدار من التعاطف الأدبي الذي لا يظهر مع المحليين والأهالي في رواياته الأفريقية و الهندية. يقع المتشرد الإنجليزي المسكين ضحية تعنيف اللبنانيين والألمان في المركب، دون أي تدخل من الراوي نايبول الذي يكتفي بأستراق النظر إلي المتشرد وهو يقرأ من كتاب صغير بصورة عاطفية علي سطح المركب، أو بأختلاس السمع له وهو يفصح عن نفسه لراكب يوغسلافي وحيد، أنه “مواطناً عالمياً”، يجوب البلدان ولا يستقر في مكان.
لم يكن لدي الآخرين، بما فيهم الأوروبيون، اهتماماً بالإنجليزي المتشرد. نايبول فقط هو من أعطاه أكبر من حجمه، حتي أن كتاب العاطفة الذي ضبطه يتلو منه علي سطح المركب تلاوة مقدسة، يتضح لاحقاً أنه كتاب نكات، في دلالة باطنة علي عدم الأستقرار النفسي، لكنه برغم ذلك لا يسحب عنه تعاطفه، بينما يظهر له الشرقيين ماديين لا يشغلهم سوي حديث السوق والمال.
في القصة الثانية، السيرك في الأقصر، الأخطر برأيي، يذهب الراوي في رحلة إلي مصر، هذه المرة بالطيران. في القاهرة منتصف الستينات يسجل الراوي مشاهداته، فندق هيلتون جديد، مرشدي المتحف الذي يعطون معرفة محلية فقط بالتاريخ، العلامات الإرشادية في الشوارع التي حُذفت منها اللغة الإنجليزية التي شكلت معلماً أساسياً من معالم شوارع العاصمة في النصف الأول من القرن، الجنود في محطة القطار الذين يمثلون الحروب التي جاءت مع الثورة.
في الأقصر ينزل الراوي في فندق وينتر بالاس، حيث يعطونه غرفة الأغاخان، ويأخذ رحلة الصحراء التي يرسل الفندق مع نزلاءه خلالها صندوقاً للطعام حتي لا يضطرون لشراء طعام غير مضمون. هنا يعطي الراوي وصفاً مثيراً لأطفال الصحراء الذين يظهرون من اللامكان، حيوانات رمال، هكذا رآهم، كانت الصحراء نظيفة برأيه، كذلك الهواء، لكن هؤلاء الأطفال بدوا له متسخين، متسخين بشدة.
كان السياح، الإيطاليين بالذات، يلهون بهؤلاء الأطفال، يلقون لهم الطعام، فيقتربون بحذر لإلتقاطه، هنا يسرع الخادم المصري في زيه الكولونيالي مفرقعاً السوط علي الرمال بجانبهم، فيهرب الأطفال مسرعين. بدت اللعبة بالنسبة للسائحين مسلية جداً، لعبة مصرية بقواعد مصرية. كانت في الواقع عرضاً ترفيهياً متكامل الأركان.
إلي أن جاءت لحظة خرج فيها العرض عن السيطرة، عندما أراد الإيطاليين تصوير فيلماً للمشهد، فرأي الخادم أن يقدم لهم معروفاً بأن يجلد الأطفال بالسوط فعلاً، هذه المرة وقع السوط علي ظهورهم أمام كاميرا الإيطاليين. يصف الراوي كيف أحس بمشاعره تثور، لم يهتم أحد بما يجري علي الإطلاق، لا الأوروبيين ولا حتي السائقين المصريين الواقفين علي مقربة، وجد نفسه يهجم علي الخادم المصري ليطرحه أرضاً، لم يجد ما يهدده به سوي “سوف أبلغ عنك للقاهرة”، عندما عاد إلي مقعده كان كل ما يفكر به برغم هذه الحركة البطولية هو أن النساء كن يتطلعن إليه مستكشفات.
في طريق العودة إلي القاهرة بالقطار، لا ينس الراوي أن يُعلق ثانية علي منظر الجنود في محطة القطار، مضيفاً جملة مذهلة في إجحافها التاريخي، لكنها مرة أخري تخضع لمعيار زمانها المكتوب قبل 1973، وهي أن هؤلاء الجنود بعد شهور قليلة سوف يختبرون هزيمة نكراء في سيناء، وسوف تمتد ظلالهم أمامهم طويلة علي الرمال وهم ينسحبون.
يقرأ إدوارد سعيد، وغيره آخرين من كُتَّاب ومفكري اليسار مثل نادين جورديمر، رسالة نايبول غير المكتوبة في هذه القصص وغيرها علي انها تعهد مسبق بتخلف وهمجية وبدائية المحليين. تأتي خطورة هذه القراءة من وجهة نظر سعيد كما أوضح في مقالته رسائل مريرة من العالم الثالث لأن نايبول قد حظي بالفعل بمكانة الصوت الممثل الوحيد والحصري لمجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس عن العالم الثالث، فكانت المسألة بالنسبة لسعيد كما هي دائماً، قضية تمثيل.
لننظر إلي صورة مصر في هذه القصة، الصورة التمثيلية الحصرية في مجلة نيويورك ريفيو وغيرها، فإذا هي مكان متخلف تخلي عن الحضارة من أجل (الحرية) –بين قوسين- فأتت عليه الهزيمة. لا يمكنك أن تنكر الحقيقة، مهما كانت “واضحة” كما يقرأ نفس القصص ذاتها، فريق آخر من اليمين السياسي، مثل مارتن آميس، سلمان رشدي، وربما أيضاً كريستوفر هيتشنز بعد تحوله، قراءة مختلفة، نافذة ومباشرة في منطقها الداخلي، علي أنها تحديقة طويلة وغاضبة في الحقيقة الواضحة كما علق آميس في مقالته هند نايبول، ولكن مهما بلغ وضوح هذه الحقيقة فيجب أيضاً أن تكون كاملة، فأي حقيقة كاملة تتكون من حقائق كثيرة صغيرة ومتراكبة، وهذا التعقيد في التركيب هو أساس أي تمثيل أمين، الأمر الذي تفتقد إليه قصص نايبول.
أما الأمر الآخر الذي لا تجده في قصص نايبول هو الأمل. في كل قصصه عن العالم الثالث تأتي الهزيمة، فتصبح المرادف الحتمي للأستقلال، لا يوجد أي أمل سوي في بروباجندا الديكتاتوريات المحلية، لكن علي المستوي الشعبي فلا شئ سوي جهل وعنف ودين، الكثير من الدين.
بين هاتين القراءتين ووجهتيّ النظر، يقف نايبول داعياً إلي حضارتنا العالمية، نظريته التي قدمها في محاضرته لمعهد مانهاتن بنيويورك، النظرية المثيرة في وضوحها وفي قلة تظاهرها الأخلاقي بالمساواة، والتي لا تقولها آدابه بوضوح قط، يدعو نايبول في محاضرته من خلال سرد قصة صعوده الأدبي، إلي حضارة عالمية مركزها أوروبا، المكان الوحيد الذي يمكن أن يحيا فيه المرء حياة العقل.
يندفع نايبول في هذه المحاضرة قائلاً أنه لم يكن بإمكانه أبداً أن يصير كاتباً في العالم المحمدي، ولا في الصين، ليس في اليابان، ولا في أوروبا الشرقية، ولا الإتحاد السوفيتي، أو أفريقيا أو الهند. الكتابة، وبمفهوم أوسع حياة العقل، تحتاج إلي صناعة، إلي ناشرون ومحررون ومصممون وطابعون وجامعي كتب وبائعون ونقاد و جرائد ومجلات وتليفزيون ومشترون وقراء، لم يمنحه أي مجتمع ذلك سوي في إنجلترا في الخمسينات. النداء الذي يلقيه ليس كما يبدو لوهلة بسذاجة “هل يجب أن نرحل جميعاً إلي إنجلترا؟” بل هو أن كل كاتب من العالم الثالث، ممتلئ بخلفيته الوطنية والعرقية، هو أيضاً، بجانب آخر من دواخله ومن ذاته علي نفس الأهمية، جزءاً من حضارة أكبر.
حضارة عقلية إذن لا جغرافية. هذا هو مقصد نايبول الذي قد يُساء فهمه بسوء الظن، فهل يمكن أبداً أن يكون المصريين في القاهرة وفي الأقصر جزءاً من حضارة أكبر؟
ندعو ونرجو ألا تتمزق أطراف الأمل الباقي.
ماجلوار- يوليو 2022